عاش يراقب الشارع السوري المقهور من نافذةٍ ضيقة لغرفةٍ رطبة ووضيعة، فغدا أبرز كتّاب قصيدة النثر العربية، ونشيد سوريا الساحر كما لُقّب غير مرّة، مع هذا عاش رياض الصالح حسين حياته مهملاً، ومات وحيداً ومطعوناً بالحزن في مستشفى المواساة عام 1982. واليوم، مجدداً، مجلّلاً بالصمت والإهمال يرحل مثقف سوري آخر، حيدر حيدر، صاحب الرواية الإشكالية "وليمة لأعشاب البحر"، كما سبقه إلى الرحيل بذات الطريقة خيري الذهبي، عادل محمود، بندر عبد الحميد، حسان عباس، ميشيل كيلو، تيسير بكسراوي، الطيب تيزيني، نبيل المالح، وغيرهم من المثقفين الذين أعادوا النظر في مسألة الحرية والهوية بتركيب مفهوم جديد لهما، فقط ليكشفوا زيف بطاركة الثقافة المائعة وديناصورات الأيديولوجيات الاستبدادية، على وقع المآلات البائسة التي حولت البلاد إلى مجرّد شعارات بائدة أو إلى تهويمات طوباوية.
مثقفون يُدفنون في مثواهم الأخير، في الوطن أو المنفى، بحضور قلّة قليلة من الأحبة، وسط تعتيم مقصود لرحيلهم المدوّي من قبل حكومة نظام الأسد. يرحلون دون وداع يليق بهم، في ظلّ مجتمعٍ بات ملعوناً ومنسياً بدوره، بعدما اشتدت التحزّبات الطائفية مقوّضة الصداقات الطويلة، ففقدت العلاقات الاجتماعية عفويتها، وتلاشت الثقة بالنفس وبالآخرين، وتحصّن الكثير علناً أو ضمناً خلف متاريس جهته التي ينتمي إليها أو قبيلته أو إثنيته، بعدما تسرّبت جرعة غير اعتيادية من الارتياب إلى أوساط الإنتلجنسيا السورية المناهضة تقليدياً للاستبداد.
من البداهة أن يكون ألدّ أعداء نظام الأسد أولئك المثقفين الذين يملكون القدرة على خرق الثوابت وكسر التابوهات، قديمها وحديثها، بابتكار الأفكار الجديدة والرؤى المستقبلية
في السياق سُئل الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان عما إذا كان هناك سلطة يخشاها فوق سلطته، فأجاب: (إنهم كبار المثقفين من المفكرين والفلاسفة والكتّاب). بهذا المعنى.. من البداهة أن يكون ألدّ أعداء نظام الأسد أولئك المثقفين الذين يملكون القدرة على خرق الثوابت وكسر التابوهات، قديمها وحديثها، بابتكار الأفكار الجديدة والرؤى المستقبلية، لتحويل المجتمع إلى ورشة من الفكر الحي والعمل المثمر، في مختلف حقوله وعلى تعدّد قواه وفاعلياته، وهذا ما لا يريده هذا النظام العبثي الذي إذا شاهد طائراً يحلّق بحرية، فإنه يُستَفز ويوجه نحوه مدفعاً وليس رصاصة، لأنه في العمق ليس إلاّ منظومة عنفية، تتعارض مع ثقافة الحداثة ونمط الحياة الكريمة، معتمداً على وسيلة أحادية في تعامله مع السوريين تتمثل بـ"ما أريكم إلا ما أرى"، ومن يخرج عن سياسة القطيع الأعمى يجد نفسه قتيلاً أو سجيناً أو شريداً.
يقول أنطونيو غرامشي، الفيلسوف والمناضل الإيطالي: (بدون المثقفين لم تشتعل أيّ ثورة رئيسية في التاريخ الحديث، وفي المقابل لم تقم أيّ حركة مضادة للثورة بدون المثقفين. فالمثقفون هم آباء الحركات وأمهاتها، وبالتأكيد أبناؤها وبناتها وحتى أبناء الشقيقات وبناتهنّ). وعليه المثقف ليس حمّال طبل للسلطة، ولا مُنوماً للمجتمع يبشره دائماً بأنه إن سكت وتبع قادته فهو على الصراط المستقيم، وهذا ما يقلق نظام الأسد في حقيقة الأمر، فالأخير لا شكّ يخاف أفكار المبدعين المضادة لرصاصه القاتل. أفكار من قبيل ما طرحه غسان جباعي في روايته اللاذعة "قهوة الجنرال" ومصطفى خليفة في روايته الشهيرة "القوقعة"، وفي المنتَجين المشاكسين يصوران عمق الهاوية التي يعيشها الإنسان في بلاد القمع والذعر، بعدما تحول الوطن إلى زنزانة فردية تسع كلّ السوريين. أيضاً من الطبيعي أن تقضّ مضجعه قصص جميل حتمل التي تنطوي على رغبة جامحة في الحياة والحرية، الموشّاة بالأحلام المكسورة بثقل القمع والقتل والتشرد. ولا بدّ هزّته ذات يوم كاميرا المخرج عمر أميرالاي الذي تنبأ قبل 2011 بالطوفان السوري المترتب على سياسات حزب البعث القمعي، وكانت مقولته الأشهر: (أعيش في بلاد تسير بشكل ثابت نحو زوالها بعدما خانها حكامها وهجرها عقلاؤها وتخلّى عنها مثقفوها).
ولعلّ من نافلة القول إنّ علاقة المثقف بالسلطة الحاكمة علاقة انفصالية تضادية، تفضح المكمون في بطون الاستبداد، وفي هذا يقول ممدوح عدوان، الذي أثار حفيظة نظام الأسد فقط لأنه تمرّد على الواقع في محاولة ليمنح الإنسان المقهور دافعاً كي ينظر بعينَي الجلاد ويصرخ رافضاً سياسة "عينك بالأرض"، يقول: (السلطات التي تكذب هي سلطات تخاف الشعب، تخاف أن يراها على حقيقتها، لذلك يقمعون رأي الشعب، يقمعون حتى سؤاله). ولهذا السبب قتلت لوحة "الأسد أو نحرق البلد" صاحبها رسام الكاريكاتير أكرم رسلان، وفيها يظهر الأسد الابن رافعاً للافتةٍ كُتب عليها هذا الشعار الذي اجتاح الحياة السورية طيلة عقود، وفي الحقيقة ما يقوله الكاريكاتير هنا ليس قاسياً، ولا يحوي مفارقة مضحكة، بل يطرح بشفافية ما كان السوريون يقولونه سراً وعلانية، غير أنّ تأسيس العقلية الإعلامية السورية وفق النوابض الأمنية المخابراتية يجعل الاقتراب من شخصية الديكتاتور جريمة كاملة تستدعي العقاب، ولهذا السبب أيضاً هُشّمت أصابع الفنان علي فرزات، واقتلعت حنجرة إبراهيم القاشوش، وقُتل النحات وائل قسطون والمخرج تامر العوّام والكاتب محمد رشيد الرويلي تحت التعذيب، كما اغتيل المخرج بسام محيي الدين حسين، وقبله باسل شحادة بقذيفة هاون في حمص...إلخ.
في الحالة السورية الراهنة تبرز الحاجة ملحةً إلى دورٍ إنقاذي واستنهاضي للمثقف، لأنه، ببساطة، الحارس الأمين المتبقي لأحلام الشعب السوري، والمدافع عن حقه في الحرية والعدالة والكرامة والسيادة
(كلما سمعتُ كلمة ثقافة تحسستُ مسدسي) هذه المقولة الشهيرة للنازي يوزف غوبلز لا تعبر فقط عن توجس النازيين من المفكرين المعادين للأنظمة الشمولية، بل تجسد مخاوف المتسلطين من الثقافة ومن تأثير المثقف ووعيه، ولهذا يقول جورج أورويل: (نحن في عصر أصبح من واجب الأعمال الإبداعية فيه أن تطلق الرصاص). وفي الحالة السورية الراهنة تبرز الحاجة ملحةً إلى دورٍ إنقاذي واستنهاضي للمثقف، لأنه، ببساطة، الحارس الأمين المتبقي لأحلام الشعب السوري، والمدافع عن حقه في الحرية والعدالة والكرامة والسيادة، وهو النبي الذي لم يُوحَ إليه في زمن "الجاهلية الأسدية"، التي تعمل على تسويق "أصولية" ثقافية ساكنة، مغلفة بقداسة منتحلة، ومرتكزة على مجتمع ثقافي يكرر مفاهيمه وقناعاته، وينزوي في كلّ آن وحين، ليتحول إلى شاهد بائس على تراجيديا ثقافية سلطوية فاجعة، تحجم وظيفته كقائد للرأي، لا يُنظر له في حدود مسؤوليته التي لا تدعو بالضرورة إلى الخروج على الحاكم بأمره.
وبينما يُحسب للطاغية السوداني عمر حسن البشير أنه خرج في تشييع جنازة الأديب البارز الطيب صالح عام 2009، وهي لربما صورته المشرقة الوحيدة، يستمر نظام الأسد في إقصاء المبدعين عن أنساق الحياة المثقلة بقوانين الاستبداد، بادعاءات غريبة، لعل أبرزها أنّ المثقف ليس سياسياً، وليس مطلوباً منه أن يقول كلمته فيما يجري من حوله. ولن نذهب بعيداً عن تبرير علّة الانهيار السوري التي ترزح تحتها هذه الثقافة البائسة وذلك المثقف المُهمل، بل والبلاد برمتها، وهي تكرّس منذ عقود التخريج العجيب للسلطوية الاستبدادية التي تخالف النواميس والقوانين الوضعية والسماوية، في وقتٍ أوجدت فيه "الكهنوتية الثقافية الأسدية" مثقفاً فصامياً، تلاحقه صرخات واقع ممزق من جهة وثقافة مثالية ومغيبة من جهة أخرى. يؤكدها الماغوط في إحدى كتاباته: (وكالجرافة حُفر الخوف بداخلي، بعدما تمّ سحبي إلى فرع الأمن للتحقيق، فكانت تلك الصفعة التي لثمت وجهي بمثابة القطيعة بيني وبين العالم. ورغم تكريم الدولة لي، ما زلت ذلك الطفل الذي ترتجف ركبتاه من الخوف عندما يُقرع باب بيتي).


 في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية
في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة
الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة
غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة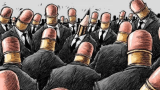 الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم..
الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم.. القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق
القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق