في ظل موجة التطبيع العربي الأخيرة تجاه نظام الأسد، كان تركيز المراقبين عموماً والسوريين بوجه خاص، يتوجه نحو المملكة العربية السعودية لجهة طبيعة التحولات في موقفها تجاه نظام الأسد، بعد كارثة زلزال 6 شباط الماضي، تبعاً للثقل الذي تتمتع به إقليمياً ولأنها البوابة الرئيسية لعودة نظام الأسد لحضن المنظومة العربية من جهة، وتطبيق أفكار ما يطلق عليها بـ "المبادرة العربية" من جهة أخرى.
إذ بات من الواضح وجود موقف متغير للمملكة تجاه الملف السوري يمكن وصفه بشكل عام بالأكثر مرونة تجاه نظام الأسد، والانفتاح عليه بحثاً عن حل ما، وهو ما ظهر عبر إرسالها للمرة الأولى لمساعدات عينية لمناطق الأسد بعد الزلزال، إضافةً لتصريحات الخارجية السعودية ومفادها "ضرورة الحوار مع دمشق"، وما تلاها من مفاجأة الاتفاق السعودي الإيراني بوساطة صينية، والأنباء عن زيارات رفيعة المستوى لمسؤولين إلى الرياض، أو أخرى محتملة لزيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق؛ لتأتي الخطوة الأخيرة عبر إعلان السعودية عن بدء مباحثات مع سوريا لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية.
الأمر الذي أثار بحد ذاته مجموعة من التساؤلات، لعلّ أبرزها هي: عن أسباب اختيار البوابة القنصلية وليس الدبلوماسية في هذه المرحلة؟ وللإجابة عن هذا السؤال يمكن الانطلاق من توضيح مفهومي العلاقات القنصلية والدبلوماسية وأوجه الاختلاف بينهما، وفق القانون والممارسة الدولية. وهو ما يسمح تبعاً لذلك بتوضيح الأسباب والدوافع لهذا التوجه السعودي من الناحية التقنية.
يمكن تعريف العلاقات القنصلية: بأنها علاقات تركز على الجوانب التقنية والفنية، من حيث تقديم الخدمات القنصلية للرعايا من تأشيرات ووثائق وتعزيز الجوانب التجارية والاقتصادية.. الخ.
من حيث المبدأ يمكن تعريف العلاقات الدبلوماسية بأنها: طريقة للحفاظ على العلاقات الخارجية للدولة، مع حكومات الدول الأخرى في الساحة الدولية. وبهذا المعنى، تعكس العلاقات الدبلوماسية أهمية الاتصال والتعاون بين الدول في مختلف المجالات، ويطلق الفقه الدولي على الجهاز الذي يتولى هذه المهمة، اصطلاحاً "بالبعثة الدبلوماسية"، والتي تمارس عملها في مبنى هو السفارة. في حين يمكن تعريف العلاقات القنصلية: بأنها علاقات تركز على الجوانب التقنية والفنية، من حيث تقديم الخدمات القنصلية للرعايا من تأشيرات ووثائق وتعزيز الجوانب التجارية والاقتصادية.. الخ.
من هذا الاختلاف يتضح بشكل مباشر الفارق في مهام كل من البعثات الدبلوماسية والقنصلية، إذ تتمثل أبرز مهام البعثات الدبلوماسية وفق ما حددته المادة الثالثة من اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن البعثات الدبلوماسية: بمهمة تمثيل الدولة، وحماية مصالحها، والتفاوض، واستطلاع التطورات، وتعزيز العلاقات. أما البعثات القنصلية، فتتمثل أبرز مهامها وفق نص المادة رقم 5 من اتفاقية فيينا لعام 1963 بكل من: حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها، وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية، وإصدار الجوازات والوثائق والتأشيرات، وتقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة أفراداً وهيئات، وأعمال التوثيق والأحوال المدنية.
يفسر الشرح السابق عن الاختلاف في معاني ومدلولات كل من إعادة العلاقات القنصلية والدبلوماسية؛ أسباب اختيار السعودية للمضي في طريق "الانفتاح على دمشق" من بوابة البعثة القنصلية وليس الدبلوماسية، إذ تعد من الناحية التقنية المحضة وسيلة لها مبرراتها من جهة، وخطوة حذرة وغير متسرعة من جهة أخرى تبقي الباب مفتوحاً على كافة الخيارات، إذ إن الموافقة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدين تعني حكماً الموافقة الضمنية على العلاقات القنصلية، في المقابل فإن العكس ليس صحيحاً، إذ إن قطع العلاقات الدبلوماسية لا ينطوي بالضرورة على قطع العلاقات القنصلية بين الطرفين. وهو ما تنص عليه المادة الأولى من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
وهذا، ما شهدته السنوات الماضية عملياً من خلال النموذج التركي، الذي أبقى على القنصلية السورية قائمة في إسطنبول رغم قطع العلاقات رسمياً مع نظام الأسد، بل والاشتباك عسكرياً معه في إدلب مطلع عام 2020، بغض النظر عن كون هذه القنصلية إحدى أدوات ابتزاز السوريين وسلب أموالهم وخاصة من جمهور الثورة السورية.
بناء على ما سبق ثمة سؤال آخر مهم وهو: أين تكمن أوجه الخطورة في الخطوة السعودية القاصرة حتى الآن على إعادة العلاقات القنصلية وليس الدبلوماسية إذاً؟ تأتي الإجابة من خبايا الممارسة العملية للعلاقات الدولية، إذ إن نقطة مهمة جديرة بالملاحظة تبرز في هذا الصدد، وهي التداخل بين كل من البعثتين.
حيث يمكن أصلاً للبعثة الدبلوماسية ممارسة المهام القنصلية، وهو وفق صريح النص في اتفاقية فيينا لعام 1961، وتوجه الكثير من الدول لأسباب "عملية" لتوحيد سلكيها الدبلوماسي والقنصلي في إطار سلك خارجي واحد، بعد أن وجدت أن الوظيفتين متداخلتين ومتشابكتين أحياناً، ومتكاملتين أحياناً أخرى، بحيث يجد الدبلوماسي نفسه يمارس الوظائف القنصلية، كما يجد القنصل نفسه في ظروف معينة كحالة عدم وجود بعثة دبلوماسية لبلاده، يقوم بالمهام الدبلوماسية.
الخطوة السعودية وإن بدت تقنية الطابع وترتبط بالجوانب العملية للمواطنين من حيث الأوراق والثبوتيات.. إلخ؛ فإنها تنطوي على بعد يرتبط بالعلاقات السياسية
وفي هذه الحالة يبرز مصطلح "القنصل الدبلوماسي" الأمر الذي يجد في نص اتفاقية فيينا لعام 1963 سنداً له، إذ أجازت المادة 17 منها، للموظف القنصلي ممارسة المهام الدبلوماسية في حالات عدم وجود بعثة دبلوماسية، أو عدم وجود تمثيل للدولة بواسطة بعثة ثالثة.. كذلك تبرز حالة عملية أخرى، وهي الحالة التي تتبادل فيها دولتان إنشاء البعثات القنصلية، ولا تتبادلان البعثات الدبلوماسية، ويكون القنصل العام بدرجة سفير، وهنا يسمح للقنصل العام بممارسة المهام الدبلوماسية أيضاً.
يشير ما سبق إلى أن الخطوة السعودية وإن بدت تقنية الطابع وترتبط بالجوانب العملية للمواطنين من حيث الأوراق والثبوتيات.. إلخ؛ فإنها تنطوي على بعد يرتبط بالعلاقات السياسية ستتم ممارسته بغض النظر عن وجود "بعثة رسمية دبلوماسية"، وهنا تمكن خطورة هذه الخطوة وما تحملها من أبعاد ستظهر في العلاقات السياسية مع نظام الأسد، والتي يمكن أن تترجم سريعاً في أسوأ السناريوهات، عبر سحب ملف بعثة الحج من المعارضة السورية إلى نظام الأسد في العام القادم، وصولاً إلى نشاط تجاري وسياحي يكسر صلابة الموقف السعودي، الذي كان دائماً حاد الطابع تجاه نظام الأسد وميليشياته وطبيعة الحل في سوريا.


 لعبة المصطلحات ومدلولاتها في الملف السوري
لعبة المصطلحات ومدلولاتها في الملف السوري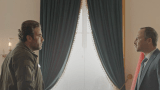 عندما تكون الدراما بوابة للبحث عن الحقائق: ابتسم أيها الجنرال نموذجاً
عندما تكون الدراما بوابة للبحث عن الحقائق: ابتسم أيها الجنرال نموذجاً قراءة في ضوء الخطوة السعودية القادمة تجاه نظام الأسد
قراءة في ضوء الخطوة السعودية القادمة تجاه نظام الأسد