كعادة كلّ الأنظمة الاستبدادية، عمل النظام السوري على تطبيق وصفات مسبقة الصنع من صنوف القهر والعسف الأمني، كي يتشرّب السوريون حقيقة أنهم مجرد أرقام هامشية تتحرك كيفما يُراد لها. كما عمل على إنتاج شبكة مفاهيم تنفي كلّ ما لا يتطابق معها، لتشكّل نظاماً ذهنياً، يتجلى في نمط تفكير أحادي اختزالي، ترسّخت في ظلّه بنية نفسية معاقة، تستسيغ الخنوع والانسحاق والطأطأة، والتهرّب من أية مسؤولية.
إنها نفسية العبيد، ولعلّ أبرز سماتها الشعور بالدونية والتبعية، وتجنّب جميع أشكال الاحتجاج الاجتماعي. على هذا يعيش العبد حياة مستقرة لكن مستعارة، وكأن صاحبها يمثل دوراً آخر في حياته، لا يعبّر عن شخصيته، ولا يمثّل ملكاته وإمكاناته، وما أودعته الطبيعة البشرية فيه. ولا شكّ أنّ الإقرار بتشكّل "مجتمع العبيد" مقدّمة أساسية لحسن قراءة المأساة السورية وتقديم الأفكار والحلول حولها. فالشخص الخائف المستلَب هو بالضرورة عبد خطاب العنف. وبلغةٍ أخرى يعاني من أوهام مطابقة للواقع الكارثي، بدلاً من أن تكون له عين على المعطيات الراهنة، لإعادة صياغتها وبنائها، في وقتٍ يهتم المستبدّ فيه بالتفاصيل اليومية اهتماماً بالغاً، ويحرص على إفقارها، وتحويرها وتشويهها، كما يغرقها بفائض معانٍ، ويمدّها بقاموس شعارات ومفردات، تشوّه كل معاني الحياة، والغاية تعطيل الوعي النقدي، وسدّ أفق الرؤى المتفائلة للكون والوجود، أيضاً إغراق الذهن بكوابيس مرعبة لأعداء مفتعلين، متربصين به كلّ حين، فتخلق حياة مسمومة تفتك بالقيم الروحية والأخلاقية.
ما كان لسيدة تدعى "سوريا حبيب علي" والتي تحولت سنة 2016 إلى قضية رأي عام، أن تقف على ضفة القهر لولا أنّ البلاد باتت فريسة المتنفذين الأقوياء الذين تنكّروا لنداء الضعفاء والضحايا
وفي بلد اختلط فيه الحابل بالنابل، غُيّب أصحاب الرأي والضمائر الحية في الأقبية والسجون والمنافي، وفُرّغت وهُمّشت المنظمات والنقابات والاتحادات من كوادرها ومحتواها السياسي والمطلبي. وعندما تشوّهت المفاهيم الإنسانية حتى أصبح مشكوكاً بأمرها، لم يتبقَّ سوى ضفتين تمثلان الشعب السوري، ولا ثالث لهما في الحقيقة. ضفة الأسياد وضفة العبيد، ضفة المطبّلين وضفة المسحوقين. وما كان لسيدة تدعى "سوريا حبيب علي" والتي تحولت سنة 2016 إلى قضية رأي عام، أن تقف على ضفة القهر لولا أنّ البلاد باتت فريسة المتنفذين الأقوياء الذين تنكّروا لنداء الضعفاء والضحايا. هذه السيدة حملت ورقة عليها أسماء أبنائها الخمسة، إضافة إلى حفيدها، الذين قتلوا، جميعاً، في الجيش التابع لنظام الأسد، وبدموعٍ مكابرة تحدثت عن حالة العوز التي تعيشها، مؤكدة أنها لم تحصل حتّى على معونة الدفن. أيضاً لم تكن لتظهر تلك المرأة التي تنتظر دورها أمام فرن الخبز منذ ساعات لتعود في النهاية خاوية الوفاض، ووسط قهرها ينطلق صوتها محتجة على الذلّ الذي يعيشه السوريون، لتحثّ ثلّة من "الرجال الصامتين" حولها على الكلام: (هادا ذل ولاّ مو ذل، احكوا ليش ساكتين، إنتو مو موجوعين متلي).
على الضفة الأخرى تقف سيدات كـ"لونا الشبل" تدعو السوريين للصمود والتصدي في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الخانقة، هي التي هاجمت سابقاً الأشخاص الذين ينتقدون الظروف المتدهورة في سوريا، ووصفتهم بـ"العملاء الأغبياء ولا قيمة لهم"، متبجّحة أنّ بشار الأسد لم يعد السوريين بشيء، وليس لديه حلٌّ للأزمة لأنه لا يملك عصا سحرية، طبعاً، باستثناء العصا المستخدمة لكشّ القطيع. أو تظهر سيدة كـ "بثينة شعبان"، وهي صاحبة الامتيازات الاستثنائية، والتي بدورها، راحت تؤكد عدمَ تأثير ارتفاع سعر الدولار على القدرة الشرائية للمواطن السوري، وبأنّ الوضع الاقتصادي في سوريا حالياً أفضل بخمسين مرّة منه عام 2011.
وفي الحقيقة لم يَعُد مصطلح "بلد العائلة" مجرّد وصف سياسي مُبسّط للحكم في "سوريا الأسد"، وإنما بات مفتاحاً لفهم المرحلة التي وصلت إليها علاقة المواطن بالسلطة، أو بالأحرى علاقة العبد بالسيد. وعند رصد جوانب هذه العلاقة، تكفي متابعة ما ينشره أبناء الحاضنة الاجتماعية للنظام في مواقع التواصل الاجتماعي، -على الأخص تلك السيدات اللاتي يصرخن عاتبات على "الأم" سوريا، وعلى كلّ من يمثلها سلطوياً-، لفهم ما آلت الأمور بينهما. ويبدو أنّ هناك بعض أمهات القتلى والجرحى ما زلن أكثر حساسية تجاه تعامل الإعلام والمنظمات السورية مع قضيتهن، مستشعرات "دناءة" المتاجرة بمعاناتهن بغرض جذب التعاطف الدولي، أو لحصد دعم مالي من جهات خارجية. فخلال الأشهر الماضية تكرّر نشر فيديوهات ناقدة من قبل نساء غاضبات بشكل غير مسبوق. لكن واحدة منهنّ لم تصب عمق المشكلة، كما فعلت "عواطف قبيلي"، والدة أحد جرحى قوات النظام، بسبب تعرّض ابنها وبقية جرحى الساحل السوري إلى إهانة كبرى، خلال حضورهم دورة ألعاب تحمل اسم "جريح وطن" عبر احتجازهم المُذِلّ ضمن الصالة الرياضية في اللاذقية، مقابل تكريم الوفد القادم من روسيا والعراق، ومع أنّ ما قالته لا يخرج -في الشكل واللغة- عن كونه بوحاً عفوياً في لحظة انفجار قهري، فإنه يصوّر بدقة توحّش الزبائنية واتساع ضفة المستعبَدين في الداخل. ونغمة الإفصاح والقهر المباح استمرت، حيث ظهرت مذيعة في التلفزيون الرسمي السوري تدعى "رنا علي" عبر فيديو مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الصمت عن القهر الذي يعيشه السوريون الغارقون بأزمات اقتصادية وخدمية خانقة. ورغم تراجعها عن كلامها بعد ساعات، لتؤكد أنها لم تشر إلى أسماء الفاسدين، بل كانت تتحدث عن وجع الشعب، ليس فقط في سوريا بل في ليبيا واليمن، إلاّ أن ذلك لا ينفي الهوّة السحيقة الكامنة بين أسياد البلد وعبيده.
من سوء حظ أولئك النسوة أنهنّ كآحاد لا قيمة لأصواتهنّ ما لم يتحدن، وإلاّ سيبقين كقطيعٍ فقدَ كلّ فرد فيه إدراكه واتزانه بينما يتحرك مدفوعاً بخوفه أو ألمه
قبلها ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على مذيعة أخرى في عملية أكدت وزارة الداخلية أنها تأتي "في إطار الجهود التي تبذلها بمكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتمّ تداولها عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وقنوات اليوتيوب لغايات مشبوهة"، والمذيعة التي تدعى "هالة الجرف" كانت قد نشرت سلسلة من التدوينات عبر حسابها الفيسبوكي، لتندّد بتدهور الأوضاع المعيشية وما وصفته بالعودة إلى "العصر الحجري". ولن يكون آخر الأصوات بالطبع هجوم الشاعرة السورية (سوزان علي) على رامي مخلوف لظهور نجله مع عارضة أزياء إسرائيلية، وعلى كلّ من يدعم النظام في سوريا.
من سوء حظ أولئك النسوة أنهنّ كآحاد لا قيمة لأصواتهنّ ما لم يتحدن، وإلاّ سيَبقين كقطيعٍ فقدَ كلّ فرد فيه إدراكه واتزانه بينما يتحرك مدفوعاً بخوفه أو ألمه. وهذا طبيعي إذا ما كان الوطن محكوماً من قتلة، يجيّرون البلاد خدمة لعقولهم التي تتربع فيها صبيانية مفرطة، تثير البواعث الأمنية كذريعة لاعتقال أصحاب الرأي المخالف أو المختلف عن الخطاب الرسمي، والنظر إليهم كمعارضة، أو حتى اعتبارهم مصدر تهديد للأمن والاستقرار. وسوريا التي تحكمها عصابة تتحكم بخيراتها كأملاك شخصية، تمنح صكوك الوطنية لمن تشاء، وتخوّن من يختلف معها، ليست إلاّ وكراً لا يمكن أن يتحول إلى وطنٍ حرّ كريم إلا إذا توقف الجمهور عن التصفيق، والصحف عن كيل المديح، ورفع آيات التهاني والتبريكات عند كلّ مناسبة، وعندما لا يتصدّر اسم "الأب القائد" صفحات الجرائد وصوره مداخل الأسواق، والحمامات العامة.
في مسرحية "شهرزاد" لتوفيق الحكيم، وعندما يخشى العبد أن يقتله الملك تسأله شهرزاد:
- هل تعرف كيف يُقتل العبد؟
- كيف؟
- بتحريره.


 في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية
في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة
الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة
غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة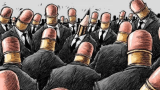 الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم..
الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم.. القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق
القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق