من زاوية تاريخية مجرّدة نستطيع الجزم أنّه من أولى خطوات طمس السمات الروحية والمادية المميزة لشعب "مستعمَر" تقديم صورة "المستعمِر"، ضمناً أو صراحة، على أنها المثالية للحداثة والتطوير، ومن ثمّ التشكيك بصلاحية العناصر الثقافية الأصيلة للشعب إياه، خاصة إذا كان يعيش عقدة إهانة كبرى بسبب هزائم ما تزال تعشش في العظام.
هذا الشعور بالنقص يدفعنا في اتجاهٍ موازٍ، لنلاحظ شيوع سلوكيات التقليد وتقمّص شخصية "المستعمِر"، إذ كلما زاد العجز زاد الإنشاء، وعليه يزداد الترهل الفكري، عندها فقط تغيب الثقافة الدفاعية التي تعاني، حكماً، من انجراح في مشاعر الأمن والانتماء، فيُساق الشعب وراء مستعمرِه كما تُساق قطعان الغنم من رعيانها.
بعض الدراسات أشارت إلى أنه من أجل السيطرة على الأفراد من الضرورة بمكان إحداث نوع من الاضطراب النفسي والسلوكي، بغرض تحضير الأرضية اللازمة لتقبل النماذج والأفعال المصممة مسبقاً، وبحكم أنّ السوريين لن يتمكنوا ببساطة من تجاوز الجروح العميقة والصدمات النفسية التي طالت النسيج الاجتماعي، يبدو أنّ التربة جاهزة لاستقبال شتى أساليب التلاعب والابتزاز من قبل الأطراف المسيطرة على الأرض السورية، روسيا على وجه التحديد، التي وحدها تستثمر معطيات الحرب استثماراً ماهراً وماكراً، بغرض تنشئة جيل مؤدلج تابع لها فكرياً، عبر زرع ولاء ثابت يتغلغل في مفاصل الحياة العامة. وهذا يعني بالمطلق زوال المقاومة ثم الاستسلام إلى حدّ التدمير الفعلي للأفكار والمعتقدات، فالوصول إلى حالة الخضوع الكامل.
سيتلقى أكثر من ثلاثمئة طفل سوري في مدينة جبلة الساحلية، دروساً في اللغة الروسية، بعد افتتاح "مركز الفجر" لتعليم اللغة والثقافة الروسية
دعونا نتذكر.. خلال خمسة عقود لم يُسمح للأكراد السوريين، على سبيل المثال، بتدريس لغتهم الأم في المدارس الحكومية ولا التحدث بها في الدوائر الرسمية، أو حتّى بافتتاح مدارس خاصة باللغة الكردية، في محاولة واضحة لممارسة شتى أشكال التهميش والاستئصال والتذويب، بدلالة أنه في عام 1987 عمد وزير الثقافة آنذاك إلى توسيع نطاق الحظر، ليشمل الأشرطة السمعية والبصرية للموسيقا الكردية استماعاً وتوزيعاً، حتّى في الأعراس والمناسبات الخاصة. في مواجهة هذه الحقيقة المؤلمة ليس بأمر جلل أن نقرأ اليوم أخباراً متنوعة في وسائل الإعلام السورية الرسمية، تعكس مدى مكر الروس في خطتهم الاستعمارية الناعمة، ومنها: "ضمن برنامج أعمال الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة نشاطات المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، تمّ في مدرسة "المنير" الخاصة بمحافظة اللاذقية وضع حجر الأساس لبناء مركز تعليم اللغة الروسية لمرحلة ما بعد الثانوية، وذلك في إطار التعاون بين جامعة "بيلوغرود" الروسية للتكنولوجيا والعلوم ومدرسة "المنير" التي تستقبل سنوياً ألفي طالب وطالبة من الحضانة وحتى الجامعة. وسيكون المركز صرحاً عظيماً ودليلاً على التعاون المثمر بين البلدين، أيضاً فرصة لنشر الثقافة واللغة الروسية، بغية إعداد الشباب الذين سيبنون سوريا، وسيحمل اسم العالم "فلاديمير تشوخوف" وهو مصمم أول ناقلة نفط ولـ (500) جسر حول العالم"...
خبر آخر: "سيتلقى أكثر من ثلاثمئة طفل سوري في مدينة جبلة الساحلية، دروساً في اللغة الروسية، بعد افتتاح "مركز الفجر" لتعليم اللغة والثقافة الروسية، حيث بثت تلفزيونات روسية تقارير عن افتتاح المركز، ظهر فيها طلاب سوريون وهم يتحدثون ويغنون باللغة الروسية، ويحملون لوحات لمدن روسية. علماً أنّ المركز يخطط لتنظيم زيارات الطلاب لروسيا من أجل الاطلاع على آثارها الحضارية والثقافية، والمشاركة في مختلف الفعاليات الإبداعية والتواصل مع أقرانهم الروس"... وطبعاً الأخبار متصلة مع فعاليات قديمة أهمها افتتاح وزارة التعليم العالي في الداخل السوري عام 2014، قسماً للغة الروسية بجامعة دمشق، لتقوم بتوسيع القسم لاحقاً ويصبح أكبر الأقسام ضمن كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كما يجري تداول أخبار عن عزم موسكو على افتتاح أول مدرسة روسية بالكامل في دمشق قريباً.
الواضح للعيان هنا أنّ ما يقوم به الروس بالتواطؤ مع النظام السوري، يمكن اعتباره حصيلة عمل مبرمج ومخطط، وليس وليد واقع راهن يقول البعض إنه يفرض ظروفه ومعطياته، إنما هو أفعال هادفة وشديدة التركيز. ولا شك أن الروس أمضوا الكثير من الزمن، وأنفقوا الباهظ من المال إلى أن وصلوا إلى إظهار نُظمهم الخفيّة التي تُنفَّذ بهدوء عالٍ لزرع الثقافة الروسية في أذهان الناشئة من الأجيال السورية.
الروس يدركون جيداً أنّ فقدان لغة يعني فقدان هوية شعب بأكمله، لذا يبدون كمن يبني "حصان طروادة" كاستثمار خبيث ورابح في حرب خاسرة
ما سبق من معطيات ووقائع يبدو توصيفاً سهلاً لما يحدث من تعبئة وتجييش في الداخل السوري، ولنا أن نتأمل في الأسباب المباشرة التي تدفع الروس لجعل الثقافة السورية أشبه بجزيرة معزولة ومحاصرة، فثمة حقيقة مُشاهدة لا جدال فيها مفادها أنّ جلّ ما حصلت عليه روسيا اقتصادياً من نظام متهالك ومهدّد بالسقوط في أي لحظة، هو عقود طويلة الأجل في مجالَي النفط والغاز، عقود غير قابلة للتطبيق في حال لم يتحقق الاستقرار التام وإعادة الإعمار. أما المتتبع للاتفاقيات الثقافية والتعليمية التي يبرمها النظام السوري مع الحليف الروسي فيدرك مدى حساسية هذه الاتفاقيات، التي لا تقل خطورة عن الاتفاقيات العسكرية والأمنية والاقتصادية التي تربط مستقبل البلدين لسنوات مديدة لا يُعرف لها نهاية.
على سبيل المثال، وليس من منطلق حسن النية أو الحاجة التربوية بالطبع، أعلنت روسيا عن رغبتها في افتتاح فرع لجامعة موسكو في سوريا، وتقديم خمسمئة منحة دراسية مجانية للطلاب السوريين، سبقها إدراج اللغة الروسية في النظام التعليمي السوري كلغة اختيارية ثانية. هذا الغزو الناعم ليس بريئاً بطبيعة الحال، فالروس يدركون جيداً أنّ فقدان لغة يعني فقدان هوية شعب بأكمله، لذا يبدون كمن يبني "حصان طروادة" كاستثمار خبيث ورابح في حرب خاسرة.
الجدير بالذكر أنّ كثيراً من الأبحاث والدراسات وجّهت حديثها عن الاستعمار من جانب سياسي وعسكري واقتصادي، ولم تعالج المشكلة الثقافية والفكرية، على الرغم من أنّ هذا الجانب هو أشد وأنكى من غيره، وهذا ما يوضح خطورة استعمار الشعوب فكرياً، وخطورة تغيير هويتها وثقافتها، إذ لم يخلُ استعمار عبر التاريخ إلا وقد مارس هذا النوع من الابتزاز، لكونه الأداة الوحيدة التي ستبقى إذا خرج من البلاد المستعمَرة، هكذا يضمن بقاء أفكاره وثقافته لتعمل على نخر هيكل الدولة المستقلة من حيث لا تشعر، وخلق العراقيل للحكومات الباحثة عن سيادتها.
وعند إلقاء نظرة على تبدلات الخريطة اللغوية السورية، نجد أنه ومنذ عام 2018، على وجه الخصوص، تشهد البلاد اهتماماً متزايداً بالتعليم العالي الروسي ليتجاوز عدد السوريين الراغبين بالدراسة في المعاهد والجامعات الروسية الحصص الموجودة بمقدار أربع مرات. ما سبق، ينقلنا إلى موضوع الثقافة وأهميتها في اللعبة الاستعمارية، فالثقافة تندرج تحت اسمها قيم وأفكار ومعتقدات تكوّن المعنى العام لحضارة الشعوب، وإذا ما هدمت هذه المنظومة الثقافية وأحلّت ثقافة "المستعمِر" بدلاً منها، يتأبّد "المحتل المتفوّق"، ويصبح صاحب أرض ووطن، ليغدو "المستعمَر" جزءاً من الماضي، يذكر في القصص أو المتاحف التاريخية. بإمكاننا الجزم في النهاية أنّ عمليات "الإبادة الثقافية" التي تشهدها سوريا والتي يمكن أن تبدو مجهولة بالنسبة للكثيرين، لكونها تندرج ضمن استراتيجية خادعة تُعرف بـ"التبادل الثقافي المشترك"، تبدو حاضرة طوال الوقت في مناطق سيطرة النظام السوري، عمليات لا يمكن التنبؤ بنتائجها الكارثية أو بنهايتها قريباً.


 في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية
في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة
الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة
غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة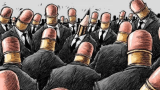 الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم..
الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم.. القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق
القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق