"منذ الساعة السابعة صباح 28/9/1961، بدأت إذاعة دمشق ببث الموسيقى العسكرية، ثم قطعت برنامجها اليومي فجأة، ليتعالى صوت المذيع: (هنا إذاعة الجمهورية العربية السورية). قبل أن يعلن، ودون مقدمات، نبأ الانقلاب العسكري الذي شُكّل بموجبه مجلس عسكري قرر فصل سوريا عن دولة الوحدة مع مصر، نتيجة الظلم الذي وقع على السوريين، كما برّر المذيع، واستمرت الموسيقى الحماسية طول النهار، يتخلّلها برقيات تأييد من الوحدات العسكرية".
بهذه البساطة تماماً كانت تجري الأمور في سوريا. بساطة فيها من التجاوزات السياسية ما مهد الطريق لاستبعاد قيام مشروع وطني سوري، تقوده زعامات بقاماتٍ عالية، تعبّئ الشعب وتوحّده. اُستبعد لجهة انعدام الحس الوطني وتفشّي ثقافة الولاءات والنزعات والأجندات الفئوية. أداء سياسي مخيّب، لا شك، بدأ منذ أكثر من خمسة عقود، لم يكن في الحقيقة سوى أول صفحة في كتاب "لعبة الهيمنة والتعويق"، في وقتٍ فشل السوري فيه في تحويل السياسة من تنازع إلى تشارك، ومن تشريف ومغنم إلى خدمة عامة ومسؤولية يتهيّبها الجميع. وعليه لا بدّ أن تمرّ لحظات تأمل كثيرة، ربما تكون خادعة أو صادقة، تدفعنا للتساؤل بجدية: كيف نريد من السوري الذي لا داراً تؤويه، أو شجرة تظلّه وسماء تحميه، أن يكون غيوراً على شيء لا يملكه؟.
ألم تبدأ الحكاية مذ بدأت الصفعات تنخر أرواح السوريين من قبل أجهزة الأمن السوري، ألم تبدأ الحكاية من هنا؟ إذاً لنسلّم، بغصة، أنّ الوطن السوري لم يعد هو المظلة الكبيرة، والدائرة التي تحوي بقية الدوائر
جدية تأخذنا باتجاه أحاسيس متضاربة، تجعلنا لا نستغرب، مثلاً، ركلَ وجه تلك المسنّة السورية من قبل رجل تركي متطرف. ألم تبدأ الحكاية مذ بدأت الصفعات تنخر أرواح السوريين من قبل أجهزة الأمن السوري، ألم تبدأ الحكاية من هنا؟ إذاً لنسلّم، بغصة، أنّ الوطن السوري لم يعد هو المظلة الكبيرة، والدائرة التي تحوي بقية الدوائر. هذا تحقّق، بطبيعة الحال، على يد عابري الصدفة والأزمة، الذين حولوا السوريين إلى جماعات لاجئة في ديار تلفظ من لا دار له.
لنتمعن مطولاً في هذه الكلمات المدغدغة للمشاعر: "بنو وطني، هذا يوم تشرق فيه شمس الحرية الساطعة على وطنكم، فلا يخفق فيه إلا علمكم، ولا تعلو فيه إلا رايتكم".. خاطبت هذه العبارة الوطنية جموع السوريين دون استثناء، تهنئهم باستقلال البلاد وجلاء القوات الفرنسية عنها. قالها الرئيس السوري آنذاك شكري القوتلي. لا مجال للاستغراب هنا.. في ذلك الزمان كان الشعب السوري قلباً واحداً وإرادة واحدة، لخدمة هدف واحد. الاستقلال. ولا يخفى على أحد أنّ سوريا ما بعد ٨ آذار ١٩٦٣ غير ما قبلها، بعدما تحولت إلى مجموعة دويلات طائفية. وبدلاً من جيش احتلال فرنسي بلغة واحدة، أصبح لدينا جيوش متنوعة اللغات. وعوض القاعدة العسكرية أصبحت لدينا قواعد متعددة الولاءات. أما الرئيس الذي كان يملك بعض السلطات أصبح هو أبو السلطات. البرلمان الذي كان يحاسب الرئيس بات الرئيس يحاسبه. المحكمة الدستورية العليا، وبدلاً من أن يُقسم الرئيس أمامها، أصبحت تُقسم هي بحياته. المؤسسة العسكرية التي كانت صمام أمان البلاد باتت تهندس صناديق الانتخابات لصالح "رئيس القطيع".
ومع أنّ الجغرافيا السورية تاريخياً لم تكن ثابتة أبداً!؟ لكنها لم تشهد إجماعاً دولياً على محوها كدولة وشعب كما هو الحال في السنوات الخمسين الأخيرة، بتواطؤ سافرٍ مع نظام الأسد!. مآلات هذا التواطؤ الخبيث أوصلت السوريين إلى دولة مقسمة، ومحتلّة. مدمّرة في إنسانها وبنيانها واقتصادها، ومصنّفة كأسوأ الدول على مستوى الأمن الغذائي والفوضى الأمنية. لا شك أنّ القوى الخارجية التهمت أي شكل من أشكال الفاعلية الوطنية، وأصبح سيناريو تغيير النظام كلاماً ممجوجاً، لا قيمة له سياسياً. رغم هذا.. الحال الذي وصلت إليه البلاد اليوم، ليس إلا الترجمة الحرفية لشعار "الأسد أو نحرق البلد". بدلالة أن عاموس جلعاد المستشار الاستراتيجي في وزارة الدفاع الإسرائيلية قال حرفياً: "سوريا انتهت. سوريا تموت. وسيعلَن موعد الجنازة في الوقت المناسب. بشار الأسد هذا ستذكره كتب التاريخ على أنه الرجل الذي أضاع سوريا". وأكثر من هذا.. يكفي مراجعة تصريحات الأسد الابن نفسه، التي نعتت السوريين، بداية الانتفاضة الشعبية، بالإرهابيين والثيران المُعلّفة، وفي أحسن الأحوال بأنهم مجرّد سوريون على الهوية فقط!..الخ، ليحضر إلى ذاكرتنا تصنيف "أرسطو" الشهير، الذي اعتبر أنّ الانسان "حيوان سياسي لا يكتمل وجوده إلا داخل المدينة". وفي سوريا لا هوية لمواطن إلا داخل ما يسمى بـ"صندوق البعث".
يقول المفكر التونسي فتحي المسكيني: "ما دامت الدولة الحديثة قد صنعت جهاز الهوية مثل أوراق الهوية وصورتها وبصمتها، وحولته إلى جدار أخلاقي وامتحان مُسلّط على رِقاب سكانها، فإن السكان لن يكونوا مواطنين إلا بثمن هووي.. بالتالي هذا ما يؤدي لمرض الدولة الوطنية، أو الأمة العُضال". بالتساوق مع هذه الرؤية يتضح أنه عندما تتفسّخ الدولة تنهدر كرامة أفرادها، وتصبح جنسيتهم بلا قيمة، ومرورهم إلى خارج الحدود مملوءاً بنكد العيش وفقدان الكرامة. ولنكن واقعيين: ما حدث مع السوري لم يحدث مع سواه من أبناء الدول المنكوبة، وإن تشابهوا في كثير من الظروف، بعدما تفشّت دعوات سامة، وجدت لها آذاناً صاغية للإساءة له وتقزيمه، وصبّ كل صفات العنصرية الوقحة عليه، لأنه ببساطة بلا أرض تحتضنه ولا وطن يتكئ عليه.
وللأسف كثير من السوريين أعلنوا استسلامهم وقبلوا أن يعيشوا مأساة لا مبالاتهم. لا مبالاتهم تجاه مصيبتهم. تجاه بلدهم. تجاه أصولهم. تجاه حقوقهم كبشر!. واليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يتوجب على السوري أن يمتلك شجاعة الأميركية ذات الأصول الأفريقية، روزا باركس، التي رفضت التخلي عن مقعدها في الحافلة لرجل أبيض، فأوقدت شرارة ثورة أنهت العنصرية والتمييز، وغيرت الأعراف والقوانين، وهكذا توالت الإنجازات حتى أصبح أوباما رئيساً لأميركا.
الأسد عمل على تسويق ثقافة الخوف والكراهية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتقديم "خدمات مجانية" للعالم بأسره، ليثبت نفسه حليفاً للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية
يجب أن يمتلكها، وهذه الـ"يجب" منوطة بالبحث عن المشتركات التي تجمع السوريين، وما أكثرها، بغية المقارنة بين سوريا المُهَلهَلة الحالية وبين سوريا قبل هذا الحكم المستبد. وأن يعترف بفروسيةِ النبلاء أنه لم يهزم في المعارك وبين البنادق، إنما الهزيمة الحقيقية كانت مبكرة، وعميقة جداً في الأرواح وليس على الجبهات، في العقول والأخلاق والأهداف والنوايا. يتوجب عليه أن يعترف أنه، هو نفسه، كان البندقية والرصاصة، لذا سقطت البلاد طفلاً وراء طفل، مدينة وراء مدينة، داراً إثر دار، وأملاً إثر أمل.
أن يعترف أنّ ما هزمه في الحقيقة هو الجهل والتسرّع وتكفير وتخوين من قاسمه غصات القهر والفقر خلال عقود. هزمته أنانيته الفردية في النجاة، التي أوصلت مليوناً إلى أوروبا، وخمسة ملايين إلى دول الجوار، ومليوناً إلى القبور. عندها سيفهم جيداً.. أنّ الأسد عمل على تسويق ثقافة الخوف والكراهية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتقديم "خدمات مجانية" للعالم بأسره، ليثبت نفسه حليفاً للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، التي تعاملت مع نظامه الفاشي كوسيط مفيد ووفيّ.
لا أدّعي أنني أملك كلاماً شافياً لكلّ هذا الخراب، لكن يتوجب على السوري أن يخرج أخيراً من نفق "النفاق والشقاق"، وبشجاعة "باركس" يكون مستعداً لتغيير واقعه، بينما يهمس لروحه الهائمة بنبرةٍ تهزّ سقف العالم: "لا شيء يستر عورة الهزيمة، لا شيء على الإطلاق، سوى الاعتراف بها".


 في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية
في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة
الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة
غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة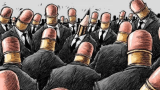 الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم..
الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم.. القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق
القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق