في أوائل القرن الثاني للميلاد، ولد لعائلةٍ سوريةٍ تسكن في مدينة سامسات (صمصاد) جنوبي تركيا على نهر الفرات، طفلٌ جميل اسمه لوقيانوس.
كانت الإنسانية حينذاك تعيش فترة "السلام الروماني" الذي نعمت به معظم أنحاء العالم القديم بفضل قوة واستقرار الإمبراطورية الرومانية، وكان العهد مؤاتياً جداً لولادة معلمين وفلاسفة عظماء للإنسانية.
عندما بلغ لوقيانوس عامه الثالث، قصّت أمه خصلة من شعره الأشقر الجميل وقدمتها كقربانٍ للآلهة السورية (اللات) كي تحمي لوقيانوس وتجعله ذا شأنٍ في المستقبل. لكن عندما أنهى لوقيانوس تعليمه الابتدائي وكان متفوقاً، أصرّ والده على إرساله إلى ورشة النحت التي يملكها أخواله كي "يتعلّم مهنة"، فالوضعُ المادّي للعائلة لم يكن يسمح للوقيانوس بالمضي في الدراسة.
في ورشة أخواله لم يُظهِر الفتى أيّ موهبةٍ في النحت، وكسر بالخطأ من أول يومٍ لوحاً من الرخام، فضربه خاله بالعصا عقاباً له، فما كان منه إلا أن ترك الورشة وهرب عائداً إلى البيت باكياً. في نفس الليلة، رأى لوقيانوس في المنام امرأةً حسناء مهيبة قدمت نفسها إليه على أنها "ربّة التعليم." يخبرنا لوقيانوس في كتابه "الحلم" أن المرأة كلّمته في منامه فقالت:
"يا بني، أنا ربّة التعليم وأنت تعلم سلفاً قيمة العلم حتى وإن لم تكمل تعليمك بعد. إن تبعتني أريتك كتب القدماء وأخبرتك بأفعالهم وأقوالهم وجعلتك ضليعاً في كل العلوم. ولسوف أبجّح نفسك بأعلى الفضائل. ستحيط علماً بما حصل في الماضي وبما يجري في الحاضر، وستملك القدرة على التنبؤ بالمستقبل. سأعلّمك كل شيء، ما تعلّق منه بالآلهة أم بالبشر".
بعد تلك الليلة، أيقن لوقيانوس أن قدراً عظيماً كان بانتظاره. لقد خُلق ليكون حكيماً ومعلماً للبشرية وليس نحّاتاً، فهو لم يخلق للنحت. قال لوقيانوس في كتابه: "وهكذا أزمعت أمري على المضي في طريق العلم ولم يقف الفقر حاجزاً بيني وبين تحقيق حلمي".
صار الفتى أكثر إصراراً على متابعة تعليمه والتخصص في الأدب والفلسفة والخطابة. وهكذا ترك لوقيانوس الورشة وشدّ الرحال إلى أيونيا، غربي تركيا، التي كانت حينذاك جزءاً من بلاد اليونان.
مع عودة العام الدراسي في شهر أيلول، يواجه الطلاب السوريون صعوبات كبرى في مواصلة تعليمهم، وخصوصاً في بلدان الجوار. وأنا متيقن أن هناك في كل مكان اليوم، حتى في سامسات المعاصرة، نظراء للوقيانوس يقاسون مع أهلهم النازحين ظروفاً أقسى من ظروف لوقيانوس قبل ثمانية عشر قرناً.
هناك درس لوقيانوس الأدب اليوناني والفلسفة في مدارسها، ثم ما لبث أن انتقل إلى أثينا ليكمل تعليمه في العاصمة القديمة. وسرعان ما أصبح لوقيانوس خطيباً ومعلّماً ذاع صيته بين الناس وتقاضى الأموال الكثيرة من عمله الجديد. أرسل لوقيانوس المال لوالديه في سامسات، ثم تابع رحلاته في أنحاء العالم القديم حتى وصل إلى إيطاليا وفرنسا، حيث اشتغل معلماً للخطابة في مدينة ليون على نهر الرون، وكان له راتب كبير جداً ساعده في العودة إلى أثينا والتفرّغ للكتابة باللغة اليونانية، التي كانت لغة العلم في ذلك الزمان. ترك وراءه خمسة مجلداتٍ ضخمة من الأعمال الفلسفية، اشتهر منها عند القارئ العربي كتاب "مسامرات الأموات"، الذي يشبه في أسلوبه "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعرّي و"رسالة التوابع والزوابع" لابن شهيد الأندلسي.
حقق لوقيانوس حلمه وصار من أكبر الفلاسفة في العالم. إن حلم لوقيانوس له ما يماثله اليوم عند ملايين التلاميذ السوريين داخل سوريا وخارجها. فمع عودة العام الدراسي في شهر أيلول، يواجه الطلاب السوريون صعوبات كبرى في مواصلة تعليمهم، وخصوصاً في بلدان الجوار. وأنا متيقن أن هناك في كل مكان اليوم، حتى في سامسات المعاصرة، نظراء للوقيانوس يقاسون مع أهلهم النازحين ظروفاً أقسى من ظروف لوقيانوس قبل ثمانية عشر قرناً، لكن هل يمتلكون ما امتلك لوقيانوس من أحلامٍ وإرادة؟ هذا هو السؤال المهم.
هناك عبرة في قصة هذا المعلّم السوري الكبير على كل طالب وتلميذ من سوريا أن يتأملها اليوم كي يفهم ضرورة التركيز على الهدف الكبير المتمثل في التحصيل المعرفي وبناء الذات رغم معوقات الفقر والتشتت وصعوبات الحياة في المنافي وفي دول اللجوء، بل حتى داخل سوريا التي ما يزال نظامها المتعفّن المهزوم رابضاً على أحلام أبنائها.
أليست أنظار الناس متجهةً إلى الذهب اليوم أيضاً؟ ألا يمالق الناس في كلّ العصور صاحب المال ويزهدون بالعالِم والأديب ما لم يكن صاحب جاهٍ وثروة؟
إن لوقيانوس لم يكن يشعر أنه غريب في أيّ أرض، وامتلك العالم بنفسه الكبيرة وعقله المبدع. فمع أن لغته الأم هي السريانية، فقد كتب باليونانية. ومع أن عائلته من سوريا فقد ولد في تركيا الحديثة، ثم أمضى عمره مرتحلاً كطالبٍ ثم كأستاذ في كل أقطار العالم حتى وصل إلى فرنسا البعيدة بمقاييس ذلك الزمان، والتي كانت تعرف باسم بلاد الغال. ويقال إنه مات في مصر في نهاية المطاف.
طالما حمل لوقيانوس في كتاباته على الكسالى والمتقاعسين وعاب على الأغبياء وطّلاب المظاهر الفارغة في الحياة. وشدّد لوقيانوس في كل ما كتب على البساطة والتواضع وأطال الحديث عن فضائل العلم والحكمة وحضّ عليهما، رغم إدراكه أن أكثر الناس زاهدون فيهما.
نسمع في "مسامرات الأموات" شكاية الفيلسوف كراتيس مخاطباً فيلسوفاً آخر هو ديوجين وهما في العالم الآخر بعد أن توفيا، فيقول: "ما أبه أكثر الناس بثروةٍ كهذه (أي الحكمة) ولم يمالقنا أحدٌ طمعاً في أن يرثها عنّا. كانت الأنظار متجهةٌ كلها إلى الذهب."
أليست أنظار الناس متجهةً إلى الذهب اليوم أيضاً؟ ألا يمالق الناس في كلّ العصور صاحب المال ويزهدون بالعالِم والأديب ما لم يكن صاحب جاهٍ وثروة؟ أليست الحكمة بالنهاية أعلى قيمة في الإنسان ما دام العمر قصيرا والحياة زائلة؟ هل يمتاز الإنسان عن سائر الحيوانات بشيءٍ إلا في عقله وعلمه؟ ما قيمة الحياة كلها لولا العقل والحكمة؟
هذه هي بالضبط قيمة الفلسفة التي تركها لنا لوقيانوس السوري. فهي ما تزال صحيحة وصالحة للتأمل حتى بعد انقضاء ثمانية عشر قرناً على موت صاحبها الذي خلّده التاريخ كواحدٍ من المعلّمين الكبار للإنسانية، ولعلّه يكون اليوم خير مُلهِم للتلاميذ والطلاب داخل سوريا وخارجها كي يزيدوا إصراراً على متابعة الدراسة وبناء الذات مهما قست الظروف وتجهّم العالم في وجوههم.

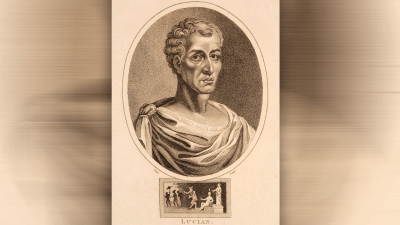
 كيف أسهمت سوريا في ولادة التاريخ المكتوب؟
كيف أسهمت سوريا في ولادة التاريخ المكتوب؟ عودة المدرسة وحلم لوقيانوس السوري
عودة المدرسة وحلم لوقيانوس السوري غوبكلي تيبي وإعادة النظر في تاريخ الإنسان
غوبكلي تيبي وإعادة النظر في تاريخ الإنسان هل انطلق الإنسان العاقل من سوريا؟
هل انطلق الإنسان العاقل من سوريا؟ محمد الماغوط في وطن الجوع والخوف
محمد الماغوط في وطن الجوع والخوف