عندما كان قسم الفلسفة في جامعة دمشق برئاسة صادق جلال العظم، يستضيف كبار المفكرين العرب للتحاور والمناظرة، أُعلن عن مناظرة بين الشيخ سعيد رمضان البوطي وأستاذ الفلسفة الطيب تيزيني صاحب الأفكار اليسارية، لكن المناظرة ألغيت، لأنّ آلافاً من مريدي الشيخ تدفقوا إلى الجامعة واحتلوا قاعة الحدث والأروقة وحديقة الجامعة، ومنعوا الضيف اليساري من الدخول.
في تلك اللحظة استشعر تيزيني خطر ما يمور في العمق السوري المستور، متنبئاً بحتمية حصول انفجار دموي قريب، سيكون له مسوغاته من دون أن يعني هذا "أنّ الشعب السوري يريد ذلك".
والحقيقة تشكل ذكرى رحيل الدكتور الطيب تيزيني والتي صادف مرورها منذ أيام، ليس فقط فرصة ثمينة للتعريج على دور المثقف السوري بالعموم، إنما أيضاً للإضاءة على شخصية اختيرت واحدة من أهم مئة فيلسوف في العالم من قبل مؤسسة "الفلسفة الألمانية- الفرنسية"، بعدما غدا تيزيني، وعبر عشرات الكتب والأبحاث، من أبرز المشتغلين على تأصيل فكر عربي صار جزءاً من تطور الفكر الإنساني.
هو الذي نشط في مجال حقوق الإنسان عندما بدا أن سوريا قادمة على التغيير بداية عهد الأسد الابن، بعدما شهد الممارسات القمعية خلال حكم الأب، فدعي للكتابة في الصحف المحلية، التي لم تحتمل دعواته لتفكيك الدولة الأمنية. والتي قال عنها: "الدولة الأمنية تسعى إلى إفساد كلّ من لم يتمّ إفساده، بحيث يصبح الجميع ملوثاً ومداناً وتحت الطلب. لقد ضاقت من ذلك الحين حياتنا وصرتُ أسمع بالقتل والتعذيب، وبدأت السجون في سوريا تفتح أبوابها بشكل استفزّ الجميع، وأصبحتُ غير قادر على متابعة الحياة، فالسياسة غير ممكنة، والعمل الثقافي يحتاج بيئة أخرى أكثر صحةً وانفتاحاً".
بالفعل تحققت نبوءة تيزيني، إذ حصل الانفجار أخيراً عام 2011. وربما من حسنات الأحداث العنفية السورية -إذا كان لها حسنات تذكر- إعادة الاعتبار للمثقف السوري على الصعيد الشعبي بالدرجة الأولى
وبالفعل تحققت نبوءة تيزيني، إذ حصل الانفجار أخيراً عام 2011. وربما من حسنات الأحداث العنفية السورية -إذا كان لها حسنات تذكر- إعادة الاعتبار للمثقف السوري على الصعيد الشعبي بالدرجة الأولى، فبالرغم من عدم فاعليته في القرار السياسي والعسكري، وانعدام تأثيره المحرك، إلا أنّ حضوره بات أكثر جرأة في إعلان مواقفه تجاه الثورة، في وقت كانت السلطة، وعبر مطبّليها، ترفض الاعتراف بأنّ رأياً آخر يمكن أن يكون حقيقة، وإن كان يصيب كبد الصواب.
ورغم مخاطر دوره القيادي، طالب تيزيني بالإصلاحات الاقتصادية وإطلاق سراح المعتقلين، يراقب بقلبٍ راجف الشعب السوري يندفع إلى الشارع بينما الألغام تتفجر تحت خطاه، لتشتعل حرب لم تبقِ حجراً على حجر، ولا يداً في يد تلملم كلّ هذا الخراب. على صعيد موازٍ اتسمت فئة من المثقفين بعيوبٍ لا تُبرّر، وكثيراً ما شاب دورها نوع مريب من الشبهات إبان الثورة السورية. مثقفون لم يميلوا للمجازفة، وكثيراً ما دغدغوا مشاعر الجمهور لزيادة شعبيتهم، حتى لو كانت مواقفهم كذباً وتملقاً، أو كلامهم فارغاً من أيّ معنى حقيقي، ولا سيما أنّ النظام السوري استثمر هذه "النزعة الشعبية" بخبثه المعهود، وحاول الاستفادة منها قدر الإمكان، لِما لها من دور كبير في التنفيس عن مشاعر الكبت والقهر لدى الناس، وتكوين وعي زائف يضع الأسباب مكان النتائج، ويحوّل المشكلات إلى حلول.
بطبيعة الحال وضعت الانتفاضة الشعبية المثقفين لأوّل مرّة أمام امتحان نوعي، لاختبار مدى عمق خيارهم الإنساني وعمق التزامهم بمعاناة أهلهم، وأعادت فرزهم بصورة أكثر حدّة وحسماً. بين من أعلن انحيازه التام إلى صفوف الحراك الثوري ودعم مطالبه المشروعة، وبين من يبحث عن ذريعة يستند إليها لتبرير انهزاميته وتردده في اتخاذ موقف واضح، وبين من زاد التصاقه بالسلطة ووقف مع أهل الحكم، وعمل على تسويغ ارتكاباتهم ونشر ذرائعهم الواهمة. هكذا مع الوقت اضمحل دور المثقف النقدي المؤثر، لتتصدر اللوحة وجوه أتقنت الترويج للوضع القائم وأسسه السيادية، وطفت على السطح ثلّة من المحازبين للسلطة أو ما درج تسميته بـ"الأبواق"، تدافع عن سياسات الأسد وجرائمه.
في المقابل بدا صاحب كتاب "بيان في النهضة والتنوير العربي" مصراً، وأكثر من أيّ وقتٍ مضى، على مساندة السوريين الذين أنهكتهم الأزمات والمحن، والعيش قريباً من معاناتهم وهواجسهم، مستعيداً رغم المرض، أفكاره ومواقفه الفلسفية، معيداً النظر في كتبه التي أصدرها وتضمّنت نظرته إلى الإنسان والعالم، قبل أن يعيش عزلته ومنفاه الاختياري في ظلّ الحرب القائمة، بعد اعتقاله على خلفية مشاركته في اعتصام وزارة الداخلية في بداية الأحداث الدامية في سوريا.
حتى آخر أيامه العصيبة عاش الطيب في منفاه متمسكاً بعقيدته: "أنه لا يوجد إلا خيار واحد كي تعيش سوريا، هو التعددية.. قدر سوريا والسوريين"
وحتى آخر أيامه العصيبة عاش الطيب في منفاه متمسكاً بعقيدته: "أنه لا يوجد إلا خيار واحد كي تعيش سوريا، هو التعددية.. قدر سوريا والسوريين"، بينما جزم باطمئنان المؤمن "أن لا أحد يملك الحقيقة المطلقة، لأنّ كل واحد يملك الحقيقة من حيث هو".
هو أمر حيوي وجوهري لا شك، أن يُعقد الأمل على دور المثقفين السوريين في مسيرة الخلاص، ربما للتعويض عن قصور المعارضة السياسية وقد شتتها أمراضها، وأضعفها القمع والإقصاء. وعليه يصحّ القول إن المثقف الحقيقي من يساهم في بناء رؤية جديدة ذات بعد نهضوي لمستقبل البلاد، كنقطة انطلاق لتجاوز ما تشهده الثقافة السورية من خسوف الاتجاهات العقلانية وتراجع المشروع التنويري.
فالثورة السورية، لا شك، ثورة طاولت الحقل الثقافي قبل السياسي، وخلقت الفرص لتأكيد التزام المثقفين بمعاناة شعبهم وحقوقه، وأيضاً لتحريرهم من حالة "النوسان" الأيديولوجي بين ثقافة الاستبداد السلطوية وبين النزعة الظلامية والعقائدية الدوغمائية. ثورة فتحت الآفاق واسعة لإعادة صياغة دور المعرفة في الحياة، وقراءة المسارات المحتملة في سياق تحولات الأحداث وتطورها كما تجري على أرض الواقع، لا كما ترسمها العقول والأفكار.
وكان الطيب تيزيني حالة خاصة، خارجة عن إطار التعريف التي عبّر عنها عالم الاجتماع الفرنسي (بيير بورديو) بقوله: "المثقفون بصفتهم أصحاب رأس مال ثقافي، فئةٌ مُهيمنٌ عليها داخل الطبقة المهيمِنة". كان ببساطة ينتمي للفئة التي تتعاطى مع المسائل النظرية والأيديولوجية، ولكن دون أن يفقدها ذلك التركيز على النظام من حيث أنه هو أصل البلاء، وعلى ثورة الحريات والكرامة من حيث أنها هي الطريق الوحيد المتاح للخلاص.
صفوة القول.. تتصف هذه الفئة المتمردة على حكم المستبدّ، بإيجابيتها في التعامل مع الشأن العام، وبإيمانها بمصالح الفئات المهمشة، وتبنيها قضية الحرية بوصفها غاية بحدّ ذاتها ويستحقها جميع الناس من دون استثناء. وإذ اعتبرنا أنّ المثقف الحقيقي، وكما يصفه المنظّر الأدبي الفلسطيني إدوارد سعيد، "إنسان يراهن بكينونته كلّها على حس نقدي، وعلى الإحساس بأنه على غير استعداد للقبول بالصيغ السهلة، أو الأفكار المبتذلة الجاهزة، أو التأكيدات المتملقة والدائمة المجاملة لما يريد الأقوياء التقليديون قوله..".
تنطلق القضية الجوهرية للمثقف السوري اليوم، باعتباره عرّاب الآلام والأحلام، من الكشف عن تشوهات السلطة القابعة داخل مفاهيم القومية والمؤامرة والمقاومة والدين والعصبيات، بوصفها كيانات ذهنية تهيمن على المواطن السوري
بناء عليه تنطلق القضية الجوهرية للمثقف السوري اليوم، باعتباره عرّاب الآلام والأحلام، من الكشف عن تشوهات السلطة القابعة داخل مفاهيم القومية والمؤامرة والمقاومة والدين والعصبيات، بوصفها كيانات ذهنية تهيمن على المواطن السوري، وتدفعه لكي يكون مجرّد تابع لها، لدرجة يفقد معها فرديته وحريته وحقوقه، لصالح ما يسمّى بالواجبات، فيتحول في النهاية إلى عبدٍ لهويته الضائعة، بحيث لا يعود هناك أي معنى لحياته خارج تلك المفاهيم الزائفة الكبرى.


 في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية
في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة
الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة
غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة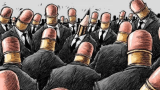 الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم..
الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم.. القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق
القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق