تُطلِعُنا الوقائع على أنّ سجلَ البشرية، ومنذ قرون سحيقة، مليءٌ بالحروب والثورات الدافعة للهجرة واللجوء، وصولاً إلى أكبر أزمة للاجئين في التاريخ الحديث وهي الأزمة السورية التي شكلت معنى جديداً في قواميس الشَتات البائدة. إنها، لا شك، أزمة تعبّر عن نفسها بشكل محايث ومشخّص، لا بشكل مجرّد ومتعالٍ في بلد يحكمه ديكتاتور ينطبق عليه ما قاله المفكر السوري إلياس مرقص: "من ليس لديه مطلق، يحوّل نسبيّته إلى مطلق، وذلكم هو الاستبداد". من هنا نرى كيف حوّل نظامُ الأسد الواقعَ، وهو المتغير النسبي، إلى أبد، مكبّلاً ملايين السوريين تحت مطلقه الفارغ، منصباً نفسه حارساً أميناً للخراب. وعليه أسوأ ما أصاب الهاربين من هذا المطلق العدمي هو الإصابة بمتلازمة العجز المكتسب، آخذين بعين الاعتبار تراتبية اليأس المتفرّع في المجتمع والاقتصاد والفكر والسياسة، القادر على الدمج والالتقاط والتأقلم.
ورغم أنّ السياق التاريخي يفتح أعيننا على حقائق مبشّرة، من مثل أنّ الذين فرُّوا من ضيق أوروبا وتعصبها إلى سعة أميركا وحريتها هم ذاتهم الذين محوا أوروبا من الخارطة السياسية كقوة أولى. واليوم تستوعب أوروبا الدرس وتبني نفسها بحرية، ومن دون تعصب، على النموذج الأميركي. رغم هذه الحقيقة المطلقة إلا أنّ هروب السوريين من بلادهم أفواجاً سرعان ما اصطدم بعُقمه، فلا أمل يذكر في بلاد أفرغت من سكانها، لتتحول إلى دولة مياومة لا يأمن ما تبقى فيها نفسه، تزدرد الذل يومياً وتُساق بالسّوط. هكذا كان الحال منذ عام 1963، وما زال يتحرك بقوة الوهم، الأمر الذي سرّع وتيرة سيطرة القيم المُغالِطة حتى تحوّل "الواقع العدمي المطلق" إلى عملية تزييفٍ مستمر للحياة، وتحوّلت فكرة القطيع المهاجر إلى واقع معمّم تحت تسمية جديدة: "نحن نموت من الأمل وليس اليأس". (اليأس غير أخلاقي، وهو احتقار للواقع) هكذا تحدّث نيتشه يوماً. لا أعني اليأس تحديداً إنما ما بعده: (ذاك اليقين بأنّ كل شيء عبث، وبأنّ تفاصيل العيش اليومية كانت تلهي السوريين عن حقيقة أنّ الحياة، بكلّيتها، محض هباء).
يبدو الانتحار كما لو أنه نظام إنذار مبكر داخل اللاجئ السوري، يعطيه إشارات على ضرورة التحرك باتجاه الخلاص من ماكينة العنف الأسدية
بالاتساق مع ما تقدّم تحدث أوسفالد شبينغلر في كتابه (أفول الغرب) عن الألوية الرومانية، التي استولت على مقدرات العالم القديم على الرغم من سوء تسليحها وتدريبها، قال: "إنها كانت غنائم وأسلاباً جاهزة لأيّ مغامر". هكذا غدت سوريا بعد خمسة عقود طاحنة من حكم عبثي دموي، ولم يعتد السوريون بعد على صور الجثث تطفو فوق المياه، ولا على استغاثة الأجساد التي تحتضر في المخيمات، ولا على حرقة الدموع التي صُبّت فوق الأسلاك العازلة حتى أصابها الصدأ... يدلّل على هذا انتفاض السوريين مؤخراً تعاطفاً مع مأساة شابٍ عشريني انتحر في لبنان، بعدما فضّل الموت شنقاً للإفلات من خطر الترحيل القسري إلى بلده سوريا. ويبدو الانتحار كما لو أنه نظام إنذار مبكر داخل اللاجئ السوري، يعطيه إشارات على ضرورة التحرك باتجاه الخلاص من ماكينة العنف الأسدية، يمكن تفسيره، ربما، على أنه خوف وسلبية أو انهزام غير مشرّف، إلا أنه يبدو أنجع جرعات اللامبالاة الدفاعية في ذهنية المصابين بمرض اليأس العضال، في وقتٍ أظهرت فيه نتائجُ مسحٍ أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حول تصورات العودة بين اللاجئين السوريين، في مصر، ولبنان، والأردن، والعراق، أظهرت أنّ 92.8% عدداً منهم لا يريدون العودة إلى بلد صيرته السياسات الجوفاء الزائفة وتكالب الداخل والخارج إلى قطعة جحيم تنذر ويلاً وسعيراً، تتسيدها مجموعة من النخب الانتهازية، والدكاكين السياسية التي لا هم لها سوى التكالب على كراسيها لتحقيق مصالحها الشخصية.
هجرة السوريين إلى الغرب غدت أشبه بنعمة الانفكاك في الزمن من العبوديَّة الأسدية بعدما تحوَّلوا إلى أقنان من دون سلاسل. من نجح في الوصول إلى جنّة المهجر لم يرجع إلى بلده إلا زائراً يتمتع بلحظات السعادة مرتين: على متن الطائرة (قبل دخول) الوطن مكتوياً بلوعة الحنين إليه، و(بعد الخروج) منه، بعد أن يكتوي أياماً في جحيمه. مفارقة محيرة بالتأكيد، وعليه يستحضرني السؤال الملح التالي: ما هذه الشيزوفرينيا التي ولدنا وتعايشنا معها؟!. نتغنى بوطن يشبه النعيم لنعيش فعلياً في جحيم اللصوص والأنذال. شيزوفرينيا جعلتنا نقبل واقع القبائل والطوائف وسط بهرجة الحداثة الكاذبة. نتفاخر في تصاغرنا، ونشرب كأس الذل ونحن نتغنى بوطنٍ "حرّ كريم" لا وجود له أساساً: مجرد فقاعة من الشعارات المبهرة والخطابات الرنانة، وهذا يفسر التقرير الصادم للمفوضية العليا للاجئين: (في كلّ دقيقة ينزح أو يهاجر /24/ إنساناً، وتتصدر سوريا أعداد اللاجئين في العالم حيث بلغوا /6.6/ ملايين من طالبي اللجوء).
عوداً على ذي بدء إنّ التأمل في هجرة السوريين أمرٌ مفيد بالتأكيد، انطلاقاً من حقيقة أنّ المجتمعات العاجزة هي مجتمعات عنيفة بالضرورة. عنفٌ يتبدى حتى في نشرات الأخبار الرسمية، والعنف بهذا المعنى هو عنف مالئ للأرواح وللأجواء، أما العيش الدائم في محاولات تجنّب هذا العنف، فهو، في جوهره، هروب صريح يرسم حدود الأمل ومضامينه، ويحدّد توجهاته في فهم الوقائع والتعامل معها، في الوقت نفسه لا يعدو كونه مراقِباً دائماً لسيكولوجيا اليأس، مسبباته وإشاراته وتحولاته. يقول المؤلف الأميركي ديل كارنيجي: (تتحقق الكثير من الأشياء المهمة في هذا العالم لأولئك الذين أصروا على المحاولة بالرغم من عدم وجود الأمل). في المقابل لا نستطيع الإنكار أنّ اليأس السوري المزمن انتحار بطيء، ثقيل ومؤلم، يضع على العين عصابة سميكة فلا تبصر بعدها أي جميل، وثمة شعب مقهور ومنهك لهول ما مرّ به، يقدّس الحزن ويخاف الفرح ويتعوذ منه مع كلّ ضحكة. أيّ موت هذا!. لكن ما يبعث على التفاؤل قليلاً أنّ اليأس يتفاعل مع المأساة السورية على نحو جديد وغير متوقع، ليفتح سيكولوجياً بوابة إلى الأمل، الباعث على الشفاء والنهوض، ولو بعد حين، فهو مبدأ أخلاقي موضوعي، فاعل في كلّ معادلات التغيير وبناء الأمم عبر التاريخ.
السوريون محكومون بقانون (العودة) كما سمك السلمون، الذي يرجع بعد قطعه آلاف الكيلومترات من المحيط إلى النهر وعكس التيار، محاطاً بالدببة المفترسة على طول الشطآن
قصارى القول.. من يفقد وطنه يفقد كلّ شيء، ومن دون حبل سري ومشيمة ثقافية محلية، يمشي فوق أرض من دون جاذبية، مُكبَّاً هائماً على وجهه، فلا الشرق يعجبه ولا الغرب يسعده، يعيش كجثة تتنفس في أرض لا اسم لها. وأجزم يقيناً أنّ السوريين محكومون بقانون (العودة) كما سمك السلمون، الذي يرجع بعد قطعه آلاف الكيلومترات من المحيط إلى النهر وعكس التيار، محاطاً بالدببة المفترسة على طول الشطآن، حتى يصل إلى موطنه الأول. إذ ما معنى تدفُّق السوريين إلى كلّ أصقاع الأرض، يحلمون بجنة أرضية جديدة، هرباً من جمهورية تجمّدت في مربعات الخوف والقهر والبؤس، تفوح منهم رائحة القلة والذلة، بعدما تحوَّل الوطن إلى طائرة مخطوفة، والمواطن إلى رهينة، والمستقبل إلى نفق مسدود، ما معنى ذلك سوى رحلة تيه لا تعرف التوقف، يتلمظون خلالها شعور الفراق الأبدي، الذي استولى على (هرقل)، إمبراطور الروم، وهو يغادر دمشق بعد الفتح الإسلامي. يقول: (وداعاً يا دمشق... وداعاً لا لقاء بعده).


 في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية
في مواجهة زعيم مملكة الكبتاغون السلطانية الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة
الثورةُ المضادة والارتدادات الثورية الناعمة غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة
غواية "حاكمات الظلّ" واستراتيجية السطوة الناعمة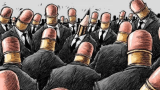 الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم..
الجاهلية الأسدية والأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم.. القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق
القطيعُ السوري المهاجر من وإلى فناء العدم المطلق