تحاشى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخوض في موضوع سلاح حزب الله، أثناء زيارتيه إلى لبنان.
وبدا تغاضيه هذا شرطاً لنجاح مساعيه في إعادة ترتيب البيت السياسي اللبناني، إصلاحاً أو تغييراً. فمقاربة ماكرون "الإنقاذية" هي منع الانهيار أو حتى "الحرب الأهلية"، وفق تحذيره وقوله. فهو يظن أن بالإمكان الفصل بين الأزمة الاقتصادية ومعضلة الإصلاحات الإدارية والأداء السياسي للمنظومة الحاكمة من جهة، وبين ما يشكله سلاح حزب الله من تهديد للكيان وتفلت للحدود وخطر استدعاء الحرب الإسرائيلية وتوريط لبنان في صراعات المنطقة من سوريا والعراق إلى اليمن، ورهن لبنان كله للسياسات الإيرانية، عدا عن كسر التوازنات الداخلية والطائفية ورعايته للمنظومة الفاسدة.. من جهة أخرى.
وظن ماكرون بإمكانية هذا الفصل، لا يشاركه فيه لا الولايات المتحدة ولا المنظومة العربية وعلى رأسها المملكة السعودية. بل إن شطراً وازناً من اللبنانيين ورغم ترحيبهم بالاهتمام الفرنسي وأثره الإيجابي على المناخ السياسي والنفسي، لا يشاطرون ماكرون فكرته ويعارضونها من منطلق قناعتهم أن معادلة السلاح الفئوي والمذهبي هي التي خربت البلاد وفرضت قسرياً على اللبنانيين خيارات كبرى لا يريدونها. وكانت مبادرة البطريركية المارونية بطرح "الحياد"، أي نأي لبنان بنفسه عن صراعات المنطقة، وأن لا يكون فيه سوى سلاح الشرعية، خير معبّر عن الشعور أن الكوارث التي حلت بالبلد إنما مصدرها الأصلي وجود سلاح حزب الله.
الاعتراض على نهج ماكرون، محلياً وعربياً وأميركياً، مرده إلى تجارب مريرة كانت معظمها على منوال مقاربة ماكرون وانتهت إلى الفشل.
ليس سراً أن الرئيس الفرنسي التقى مرتين النائب عن حزب الله محمد رعد. وفحوى اللقاءين، إقناع حزب الله بأن تسهيله لخطة الإنقاذ الفرنسية هي بمثابة طوق نجاة للحزب من الضائقة الشديدة التي يعانيها منها هو ولبنان كله، وتخفف من النقمة عليه محلياً ودولياً.
وبالفعل، رحب حزب الله بالتدخل الفرنسي إلى هذا الحد بالشؤون اللبنانية لما يحمله من فوائد سياسية واقتصادية. والأهم أن وضع ملف السلاح جانباً وعدم الخوض في أمور استراتيجية: الحدود، المعابر، المرافئ والمرافق، وانتشار حزب الله في المنطقة، وسيطرته على القرار السياسي في الدولة.. تنحية كل هذا عن النقاش يدعم ادعاء الحزب القائل أنه بريء وسلاحه من الكوارث التي حلّت بالبلد.
"الانحناءة" التي فعلها حزب الله أمام الحضور الفرنسي، أتت بالضبط لأن ماكرون فتح مخرج طوارئ للحزب ما كان يحلم بها، بعدما أصبح واضحاً أن الحزب "مسؤول" عن المسار الكارثي للبنان في السنوات الأخيرة. بل مسؤول عن منع الإصلاح والتغيير وعن حماية الطبقة السياسية التي باتت خاضعة له مقابل استمرار نيلها للمغانم.
على الأرجح، سيحصد إيمانويل ماكرون بعض الإنجازات، على مستوى زيادة المساعدات الإنسانية، أو في تشكيل الحكومة الجديدة، أو في بعض الخطوات الإصلاحية المتعلقة بمالية الدولة اللبنانية، وربما سيفرض على حزب الله بعض التهذيب أو تحسين السلوك. لكن هل هذا يكفي؟
برأي المعترضين على مقاربة ماكرون، أن ما يفعله الأخير يؤجل المشكلة ولا يحلها، ويمدّ حزب الله وحلفاءه وشركاءه بالأوكسيجن، ليس إلا.. والسبب كما قلنا أعلاه، هو تاريخ التجارب المشابهة لخطة ماكرون التي انتهت إلى انقضاض الحزب على هكذا اتفاقات ما إن يستعيد عافيته ويخرج من ضائقته. وبمعنى آخر أن البدء بالسيطرة على الأفعى من ذنبها دون رأسها يؤدي انغراز أنيابها في عنق المغامر الأحمق.
في العام 2000، وعقب جلاء الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان، كان السؤال المنطقي هو حول مستقبل سلاح "المقاومة" بعدما أنجز مهمته. وكان جواب الحزب ونظام الأسد اختراع معضلة مزارع شبعا، ثم الانقضاض على الدولة اللبنانية بالمزيد من التشدد وتسليط نظام أمني مشترك سوري – لبناني.. والتنكيل بالمعارضة السياسية وتكبيل الحريات. والأهم هو قرار الحزب بالدخول لأول مرة إلى الدولة والبرلمان.. وتالياً إلى مجلس الوزراء. تحول السلاح من أداة مقاومة وتحرير إلى أداة تسلط وغلبة.
وكان هناك نهج سياسي محلي وعربي ودولي يشجع الحزب على الدخول في الحياة السياسية، بظن أن ذلك لا بد أن يلبننه، وتالياً يتخلى عن سلاحه لدولة هو شريك فاعل فيها. خاب ظن سريعاً.
في خريف 2004، جاء القرار 1559 الأممي الذي ينص على ما يماثل بنود اتفاق الطائف، وأكثر شدة في موضوع "نزع السلاح" وحل الميليشيات. القرار أتى "إنقاذاً" للبنان من وصاية الأسد ومن سلاح حزب الله وتأميناً له من أي حرب إسرائيلية محتملة، عبر جعله بلداً مسانداً في المنظومة العربية وليس دولة مواجهة بالإنابة عن إيران ونظام الأسد.
الجواب الذي قدمه نظام الأسد وحزب الله لم يتأخر كثيراً: تفجير لبنان عبر سلسلة اغتيالات أشهرها وأشدها إثارة للصدمة هو اغتيال رفيق الحريري.
مرة أخرى، حاول اللبنانيون المناوئون لحزب الله كما العرب ومعظم الدول الفاعلة، تحييد حزب الله عن المواجهة المفتوحة مع نظام الأسد. بل إن حركة 14 آذار قدمت مقاربة سياسية تقول بتحاشي "عزل" حزب الله الذي قد يؤدي إلى "عزل" الشيعة اللبنانيين ما يفضي إلى انقسام أهلي وربما حرب أهلية. ولذلك، افترضت 14 آذار أن أفضل طريقة هي تقديم الهدايا ومخرج الطوارئ للحزب وخوض حوار وطني يحفظ مكانة الحزب في الصيغة اللبنانية. بل إن 14 آذار عقدت في أواخر ربيع 2005 ما سيعرف بـ"الحلف الرباعي" بالانتخابات النيابية، عبر خوضها بلوائح مشتركة مع مرشحي "الثنائي الشيعي"، حزب الله وحركة أمل.
ما إن شعر حزب الله بالراحة وبانفكاك الحصار والضغط، عقب تلك الانتخابات، حتى انقضّ مجدداً مستأنفاً الاغتيالات وسياسة العنف والقوة.
فشل تلك التجربة في تغيير سلوك الحزب وسياسته، أدى إلى صراع سياسي ومعاودة الهجوم العربي والدولي على حزب الله وحلفائه، خصوصاً أن التحقيق والدلائل بدأت تشير بوضوح إلى مسؤولية الحزب على العنف الدموي والاغتيالات.
مرة أخرى، أتى جواب الحزب بالأسلوب الذي يجيده: اخترق الحدود وافتتح حرب عام 2006. ولما كان الرد الإسرائيلي بالغ التدمير، فإن الحزب ورغم أدائه القوي في الميدان، كان يسعى باستماتة لوقف الحرب بأسرع وقت.
كل المفاوضات التي خاضتها المجموعة العربية وأميركا والدول الأوروبية المؤثرة والحكومة اللبنانية لصياغة القرار 1701، كانت متمحورة حول أن يكون القرار وفق الفصل السابع (أي التنفيذ الفوري ولو بالقوة). وكانت خطيئة الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة أنها أقنعت بعض الأطراف، لعدم اللجوء إلى الفصل السابع، وتنبي وجهة النظر التي تقول إن مشكلة السلاح مسألة داخلية تحلّ بالحوار الوطني. كان هذا بظن أن هكذا "هدية" أو حبل نجاة لحزب الله قد تجعله يقبل بما سيسمى "الاستراتيجية الدفاعية"، أي حل الميليشيات وإدخال سلاحها في كنف الشرعية والجيش اللبناني.
أوحى حزب الله أنه مستعد لكل ذلك. لكن ما إن نجا من الحرب ومن امتحان الفصل السابع، حتى انقض على حكومة السنيورة نفسها وحاصر السرايا واحتل وسط بيروت.
وعلى هذا المنوال يمكن سرد ما حدث تالياً، في العام 2008 وصولاً إلى اليوم. وماكرون الآن يعيد التجربة اللعينة نفسها.


 حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً
حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث
حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث  إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله
إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله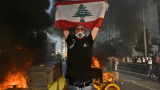 "جهنم" لبنان لم يبدأ بعد
"جهنم" لبنان لم يبدأ بعد حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا
حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا